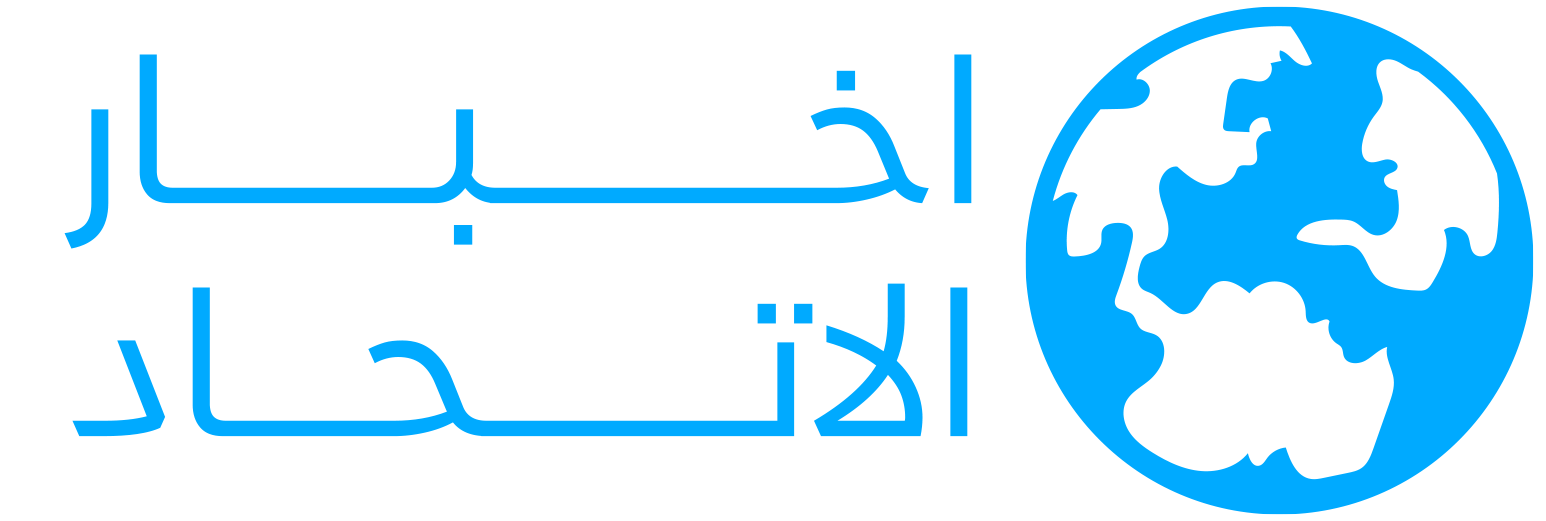الشرق الأوسط الجديد.. ولكن أين جديده؟
[
]
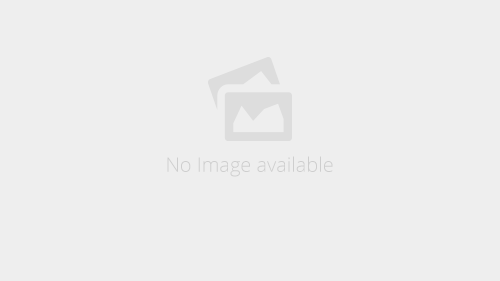
هالة محمد جابر الأنصاري
ما يلفت الانتباه عند الحديث عن تداعيات حرب الاثني عشر يوما التي عصفت بالمنطقة، وجاءت كفقرة مرسومة ضمن مخطط كبير جارٍ تنفيذه لإعادة توزيع مراكز الثقل على أراضيها وتقليم أظافر مشاغبيها، هو التبشير بولادة شرق أوسط بنسخة جديدة. نسخة لا نعرف صيغتها القادمة بالضبط، وإن كنا قد علمنا حدودها الجغرافية وما تأتي به من تشابكات وتداخلات جيوسياسية واجتماعية تزداد تعقيدا بين المتنافسين على كرسي الحاكم الأوحد لهذا الشرق.
مصطلح “الشرق الأوسط الجديد”، ومنذ أن برز على طاولات الرمل المعنية بترسيمه، يشير إلى كيان جيوسياسي يعيد تشكيل ارتباط بعض الدول العربية بعمقها الاستراتيجي وخارطتها الجغرافية الكلاسيكية كأمة عربية واحدة. إذ تنضم إليه، وفق التصور الأكثر تداولا، دول مثل إيران وتركيا وإسرائيل، وتمتد حدوده إلى عُمان في الشرق ومصر في الغرب. وأحد المبررات الشائعة لهذا التصنيف الجغرافي هو التفريق بين دول الشرق المتوسط ودول الشرق الأقصى!
ومع تصاعد التوترات على أراضي هذا التكتل، نتساءل لفهم المبررات “غير الشائعة” والغرض الحقيقي من “تجديده”. فهل نفترض أن نسخة الشرق الأوسط “الجديد” ستنجح في فرض واقع أكثر تفاؤلا، حيث يتفاعل لاعبوه الرئيسيون ضمن شبكة علاقات تحتكم إلى لغة العقل وتمارس الواقعية السياسية التي تنمي موازين المصالح المشتركة، وتعتمد مسار التفاهمات الدبلوماسية؟ أم أننا سنصطدم في كل مرة بأزمات شبيهه بـ”الانفجار الكبير”، الذي وقع في حزيران الماضي ونعود إلى ساعة الصفر الكارثية، حيث ينشغل الجميع بـ”إدارة الصراعات” وتعليقها، بدلا من العمل على إنهائها؟
ولا بد لنا ونحن نحاول فهم “جديد” الشرق الأوسط، أن نرجع بالتاريخ للوراء. فأول من بشّر بالفكرة والتوجه لم تكن كونداليزا رايس، كما يُشاع منذ انطلاقة شرارة التاسع من سبتمبر (2001) وتداعياتها على المنطقة، بل شمعون بيريز، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وأحد عرّابي اتفاق أوسلو (1993)، كما يتضح في كتابه الصادر بعد إبرام الاتفاقية، والذي حمل العنوان ذاته.
كتاب بيريز يُعدّ اليوم من المراجع التاريخية ذات الصلة لفهم القصد الغربي من صناعة شرق أوسط “جديد”، حيث تكون فيه إسرائيل اللاعب الأساسي في ضمان أمن واستقرار المنطقة. فبحسب الرؤية “البيريزية”، فإن مركز القيادة يتطلب انسلاخا تاما عن اقتصاد “قائم على الحرب”، بتبني نهج جديد يؤسس لاقتصاد “قائم على السلام” لتحقيق التحول في موازين القوى للصالح الإسرائيلي.
وهذا لن يتم – والرأي لصاحب الكتاب – إلا عبر اتفاقات صلح تضع في حسبانها أن التهديد الأكبر لإسرائيل لا يتمثل في قضية الصراع مع الطرف الفلسطيني، بل في تزايد التهديدات الأصولية الصادرة من الجانبين، وتنامي القدرات النووية الإيرانية واعتبارها العدو الأخطر. هذا غير تصوراته الحالمة لشرق أوسط جديد تحكمه التحالفات الاقتصادية، بلا حواجز طبيعية بين بلدانه! متجاهلا، كالعادة، الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ضمن رؤية عاجزة عن تأسيس قاعدة للمصالح “المتكافئة” ليصبح السلام “العادل” أصلا لا استثناء.
وأعتقد أن الاختلال الفكري لهذا المشروع المتجدد في طرحه لا يزال قائما، من حيث افتقاده لعناصر الثقة المتبادلة والوضوح في النوايا، واستمرار بعض أطرافه في تبني المشاريع التوسعية التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية التي تطالب باحترام حدود الجيرة بين الدول وكفّ يد التدخلات الفوضوية في شؤونها. هذا فضلًا عن المجازفات غير المبررة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة الجبرية، مما يجعل إمكانية قيام نسخة جديدة من هذا التكتل أو التحالف الجيوسياسي أمرا شديد الصعوبة، خصوصا على صعيد إعادة بناء علاقات الثقة بين دوله ونبذ كل أشكال الكراهية والعداء وتجفيف ما يغديها، لعلها تتوفر بعد ذلك أبسط اشتراطات التعايش المشترك والتفاهم المتحضر في محيط جغرافي قادر على “تصفير” مشكلاته.
وفي الخلاصة، فإن الحديث عن قيام شرق أوسط جديد يبدو اليوم كنوع من الترف الفكري والتنظير البيزنطي البعيد عن الواقع، ليظل المصطلح مجرد مفهوم مبهم وخديج تغذيه التعقيدات السياسية والمصالح الأحادية والصراعات التي لا تنتهي بين أبرز لاعبيه.